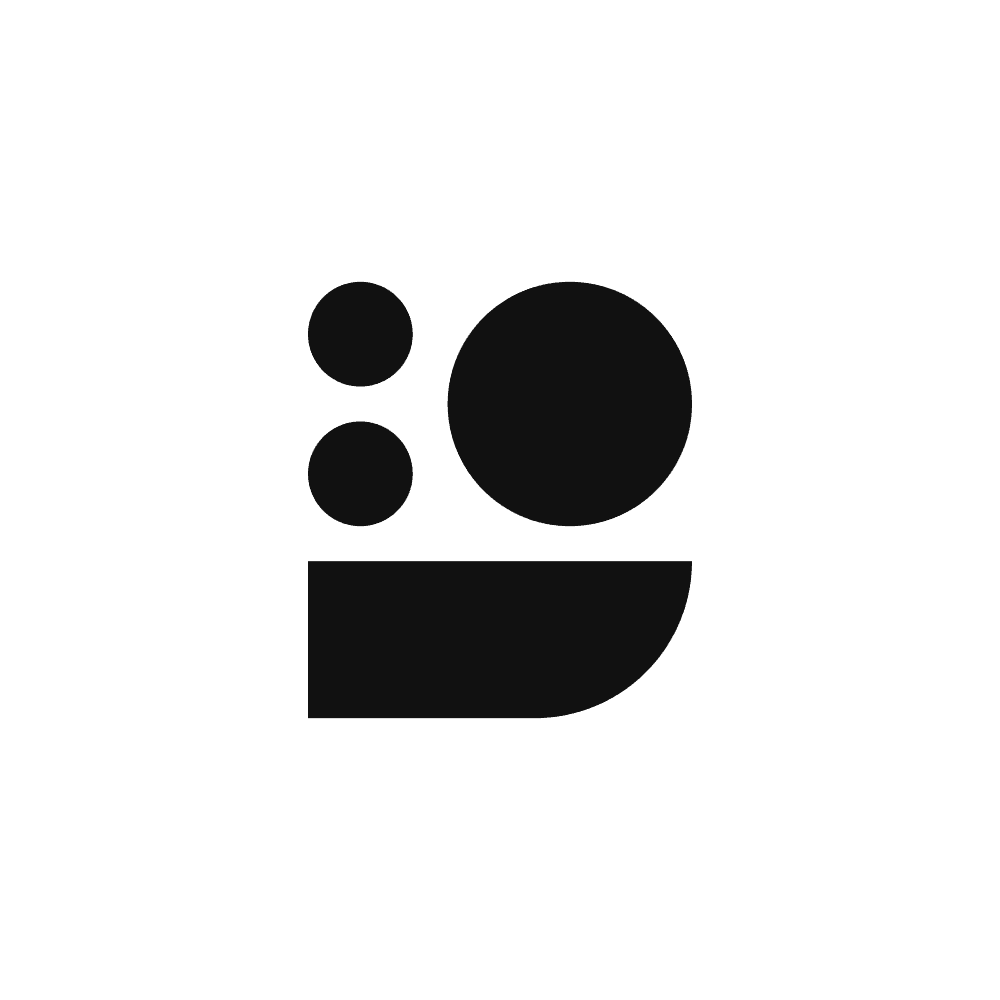تمهيد:
ماذا لو بدأنا من الصفر؟
لا يوجد نظام تدريبي (Learning Management System - LMS)، ولا مرجع تعليمي نحتكم إليه، ولا حتى تعريف واضح لما يجب أن يكون عليه التعلّم في واقع العمل المعقد اليوم.
ضمن هذهِ الافتراضات، طرحنا سؤالًا واحدًا:
كيف نبني نظامًا تدريبيًا ينمو ويحقق أثرًا طويل المدى في عقل المتدرّب؟
بهذا المنهج من التفكير، وُلدت فلسفة "عناصر التدريب الإنساني"، 12 عنصرًا استخلصناها بعد بحث عميق، وقراءة عشرات الكتب المتخصصة، ومراجعة ممارسات عالمية، حتى توصّلنا إلى معادلة التدريب التي تجعل المتدرّب يفكّر، ويطبّق، ويصنع التغيير.
في هذه السلسلة، سنفكّك التصوّرات الخاطئة عن كل عنصر، ونقدّمه من جديد برؤية مختلفة مدعومة بنموذج تصميم تدريبي استراتيجي (Strategic Instructional Design Framework)، إضافةً إلى توضيح كيفية تُجسيد هذه الرؤية في نظام مساق التدريبي.
هذا المقال للعنصر الذي من خلاله يُدرِّب الإنسان ويتدرّب، المنصّة.
المنصّة ليست مجرد إجراء شكلي
تغيير إطار اللوحة من خشب إلى ذهب، لن يجعل اللوحة تبدو أجمل!
هذهِ هي العقلية التي تُتبع عند نقل نفس المحتوى التدريبي إلى المنصة، من دون معالجة فعلية إلى جودة المحتوى التدريبي نفسه. عندما تنقل المؤسسة التدريب إلى المنصة تعتقد بأنَّ هذه الخطوة هي رهانها الرابح، وتفترض أن بمجرد إطلاقها يعني أنها حققت النضج في التحوّل الرقمي في التدريب المؤسسي. ولكن هذه القفزة السريعة من الرغبة في التدريب إلى تنفيذ المنصّة، تتجاهل سؤالًا جوهريًا: هل هذه المنصّة تعكس فعليًا رؤية المؤسسة في التدريب؟ أم أنها مجرّد إطار تقني تُغلّف هشاشة معرفية لم تعالج بعد؟
في كثير من الأحيان، تخلط المؤسسات بين بناء نظام تعلّم رقمي (Digital Learning System) وبين مجرد رقمنة المحتوى (Content Digitization)، فتظن أن خطوة رفع الشرائح، أو تسجيل المحاضرات، أو ربط الاختبارات بلوحة تحكّم البيانات ستعالج مشكلة التدريب. لكن الحقيقة أن المنصّة لا تنظّم شيئًا إن لم تكن الرؤية المعرفية للمؤسسة واضحة من الأساس. فالمؤسسة التي ترى التعلّم كمسار طويل المدى، ستبني منصّة تحترم هذا المسار، بينما المؤسسة التي ترى التدريب كوسيلة لتقليل الأخطاء التشغيلية، ستبني منصّة تدور حول التحكم والضبط، لا حول المعرفة والتفكير التحليلي (Knowledge and Cognitive Growth).
وتزداد هذهِ الفجوة بين الرؤية والتطبيق عندما تستورد المؤسسة منصّة عالمية تدريبية جاهزة (Off-the-shelf LMS) وتطبّقها كما هي، مفترضةً أنها صالحة لكل مكان وسياق من دون أن تسأل نفسها: هل تتناسب هذهِ المنصّة مع أهدافنا التدريبية وبيئة عملنا؟ هل لغة التدريب، وقنواته، وأدوار مستخدميه، تعمل بذات المنطق؟ المنصّة المصمّمة لثقافة أخرى، مهما كانت متقنة، قد تعيق التدريب أكثر مما تُسهّله، لأنها تفترض سلوكًا تدريبيًا لا يشبه ثقافة المؤسسة، وتحقق أهداف لا تعبّر عن أولوياتها التدريبية.
في نهاية المطاف، المنصّة ليست منتجًا وظيفيًا محايدًا، بل هي انعكاس لنضج المؤسسة في فهمها للتدريب المؤسسي، ليس فقط على مستوى التقنية، بل على مستوى الرؤية التي تنظم بها علاقتها بالمعرفة، وبالإنسان (المتدرّب.)

زوايا عمياء في المنصّة التدريبية
قبل أن نشرع بإيجاد الحلول، لا بد أن نتعمق أولًا في عنصر المنصّة، ونصحّح الأفكار المغلوطة عنه.
المنصة أداة لإثبات وجود التدريب
يستخدم بعض الأشخاص المصطلحات المنمقة، والكلمات المتحذلقة لا لأنها تسهم في إيصال فكرته بشكل أفضل، ولكن، فقط من أجل أن يعطي انطباع للآخرين أنه مثقف، وحاذق. في سياق التدريب كذلك، ليست كل منصّة تدريبية Training Platform تُبنى لأجل التدريب، أحيانًا يكون الهدف أداء واجب شكلي.
حين تبني المؤسسة المنصّة كدليل إثبات، لا كأداة تحوّل، فإنها، من دون وعي، تستخدمها لتبرير وجود التدريب بدلًا من تفعيله. فتصبح إطلاق المنصّة خطوة تُحسب في التقارير، لا في واقع العمل؛ تُثبت بها الإدارة أن التدريب قد حدث ووُثِق، حتى وإن لم يُحدث أي تغيير فعلي في أداء الموظفين أو في فهمهم لما يُفترض أن يتعلّموه.
بهذه العقلية، لا تكون المنصّة سوى خطوة شكلية، تمكّن المؤسسة من إثبات استثمارها في التدريب، من دون أن تمتلك رؤية واضحة لما تريد تحقيقه من تغيير أو نتائج.

المنصّة تكافئ الإنجاز، لا الفهم
عندما تذهب إلى النادي الرياضي، هل يكون هدفك الذهاب فقط أم ممارسة الرياضة؟
بعض المنصات التدريبية مصمّمة بطريقة تجعل الهدف منها هو الإنجاز بحد ذاته، لا التدريب، لأنها تُكافئ من ينجز أسرع، لا من يفهم بعمق، ويتطور. فيُحسب النجاح بالوقت الذي قضاه المتدرّب في المنصة، أو بعدد الإجابات الصحيحة في الأسئلة متعددة الخيارات، ثم تُمنح الشهادات لكل من أكمل الدورة، بغض النظر عن إذا فهم المحتوى، أو أعاد التفكير في مفهوم ما.
بهذا المنطق، تُعيد المنصّة إنتاج ثقافة الأداء الظاهري الذي يعزز أهمية إكمال المهمة، لا أهمية التفكير، والسؤال، لأن هذه المؤشرات لا تقرأها المنصّة، أو تُكافئ عليها. فيتحوّل المتدرّب إلى مؤدٍّ، لا متعلّم. يرى النجاح في اجتياز المسار، لا في التعمق فيه. وتتحوّل الدورة التدريبية إلى مسار سريع للإنجاز، بينما التعلّم الحقيقي يحتاج إلى تفكير عميق ومتأنٍ، يُصقل بالتجارب، ويُعزّز بالتطبيق.
هذه المنصّات، لا تسمح للمتدرّب بأن يتأمّل، بل تشجّعه على المرور. وتؤطّر النجاح في مؤشّر شكلي لا يعكس تغيير حقيقي في المتدرّب، لأن المنصّة لم تُبنَ لتقيس الفهم، بل لتقيس إكمال المهمّة.

المنصّة تُركز على ما يُمكن قياسه، وتتجاهل ما يهمّ فعلًا
تفاعل الناس مع عمل تلفزيوني في منصات التواصل الاجتماعي يمكن قياسه بعدد المنشورات، والتعليقات، والمشاركة، ولكن هذه المؤشرات لا تقيس بالضرورة الجوانب الأهم غير القابلة للقياس مثل مقدار التأثير الذي يحدثه العمل، أو الوعي الذي يغيره في عقول المشاهدين.
كذلك في البيئات المؤسسية، لا يُبنى القرار دائمًا على ما هو مهم، بل على ما هو قابل للقياس. وهنا تظهر المفارقة: تُصمَّم المنصّة لتُنتج بيانات واضحة، سهلة القراءة، تُستخدم في إعداد التقارير ومتابعة مؤشرات الأداء التدريبية (Training KPIs)، لكنها، في المقابل، تُغفل ما لا يمكن تتبّعه رقميًا بسهولة، حتى وإن كان هو جوهر التدريب. فتُظهر المنصّة عدد الدقائق التي قضاها المتدرّب، وعدد المحاولات التي قام بها، ونسبة الإجابات الصحيحة، لكنها لا تُظهر إن كان المتدرّب حائرًا أثناء المحتوى، وإن كان قرّر التوقف لأنه لم يقتنع، أو أنه ناقش المفهوم مع زميله. لا يمكن للمنصّة أن ترصد لحظة الفهم، أو لحظة التشكيك، أو قرارًا داخليًا اتّخذه المتدرّب ليُغيّر سلوكه بعد التدريب.
وهكذا، تصبح البيانات انتقائية، تعكس الصورة التي تُرضي التقارير فقط، لا الحقيقة التي يمكن البناء عليها. عند ذلك، يصبح التدريب سطحي لأنه يركز على ما يُقاس رغم عدم أهميته، ويتجاهل الأعمق لعدم إمكانية قياسه.

إعادة تعريف المنصّة في التدريب المؤسسي
المؤسسة التي تسعى لإحداث التغيير لا تُعامل المنصّة كأداة لتفعيل حدثٍ تدريبي عابر، بل كمسار تدريبي يهدف إلى التعلّم المستمر (Continuous Learning). فلا تُصمَّم المنصّة بحيث يودعها المتدرّب عند إتمام الدورة، بل يعود إليها للمراجعة ومواصلة رحلة التدريب. فيتحرّر التدريب من منطق الإكمال وينتقل إلى منطق التأثير.
لكن الدور الأعمق للمنصّة لا يظهر في تجربة المتدرّب فحسب، بل في ما تُتيحه من محاكاة واقعية للسلوك المهني (Workplace Simulation). على المنصّة أن لا تكتفي بعرض المحتوى، بل تخلق بيئة تطبيقية آمنة تُحفّز المتدرّب على التعلّم بالتجربة (Experiential Learning)، فيتمرّن من خلالها على اتخاذ القرار، وحل المشكلات، وتطبيق المهارات السلوكية (Behavioral Competencies) المطلوبة في عمله الفعلي، دون الخوف من التقييم أو الخطأ. هي مساحة تجريب مصغّرة، تحاكي تعقيدات الواقع المهني وتدرّب المتدرّب على مواجهتها، ليخطئ ويتعلّم، لا ليحفظ ويكرّر.
بهذا التوجه، تترجم المنصّة فلسفة المؤسسة في التدريب، فتمنح المتدرّب المساحة للتمرين، وإعادة المحاولة، بدلًا من أن يُشجَّع على الإنجاز بحد ذاته.

كيف تتحوّل المنصّة إلى بيئة نمو حقيقية؟
إذا أردنا أن تتحوّل المنصّة من قناة لتوزيع المحتوى إلى تجربة تدريب حقيقية، فنحن بحاجة إلى إعادة التفكير في ما تتيحه من تجارب وأنشطة. لا يكفي أن تُنظم الوحدات، أو تُربط الأنشطة، أو تُرصّ الصفحات؛ بل يجب أن تُصمَّم لتقود المتدرّب في مسار نمو حقيقي، يمر فيه بأهداف تدريبية متنوّعة تتجاوز مجرد الاطلاع.

المنصّة الإنسانية تُمكّن المدرّب من توظيف أدوات المنصّة لتحقيق هذه الأهداف، بدلًا من العرض التقليدي للمحتوى.
تخصيص إعدادات المنصّة في نظام مساق التدريبي
حين نعيد تعريف المنصّة كمساحة للتدريب والتجريب المهني، تصبح إعداداتها جزءًا أساسيًا من التجربة، لا مجرد تفاصيل تقنية. فخيارات مثل تخصيص اللغة، ورسائل النظام، وتنسيق الموقع، تتيح للمؤسسة مواءمة المنصّة مع بيئتها وثقافتها وسياق متدرّبيها.
هذه الإعدادات تمنح المنصّة طابعًا إنسانيًا، وتجعلها أكثر قدرة على دعم الأهداف التدريبية بمرونة وتكيّف، بدلًا من فرض قالب عام على المتدرّبين. لذلك صمّمنا إعدادات المنصّة في مساق بحيث تكون مرنّة، ومخصّصة لكل مؤسسة بسهولة عن طريق هذه الميزات:
باني الموقع
يتيح تصميم واجهات المنصة، مثل الصفحة الرئيسية ولوحات التحكم، بما يتماشى مع هوية المؤسسة واحتياجاتها التشغيلية، من دون الحاجة لأي معرفة برمجية.
العلامة البيضاء (White-labeling)
تمكّن المؤسسة من تخصيص مظهر المنصّة بالكامل: الشعار، الألوان، الخطوط، وحتى اسم النطاق (Domain)، لتظهر وكأنها نظام داخلي خاص.
تخصيص رسائل النظام
تتيح تعديل نصوص الرسائل التلقائية التي يتلقّاها المتدرّبون (مثل إشعارات التسجيل أو الإكمال)، لتتناسب مع نبرة المؤسسة وأسلوبها.
التكامل مع الأنظمة الخارجية
تتيح المنصّة ربطها بأدوات مثل Zoom، نفاذ، Google Calendar، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، إلى جانب دعم تكاملات مخصصة عبر OAuth2، لتتكيف مع بنية المؤسسة التقنية.
محفزات الأحداث (Event Triggers)
تسمح بتحديد أحداث معينة (مثل التسجيل أو إكمال دورة) وربطها بإشعارات فورية مخصصة، مما يوفّر تواصلًا آليًا متلائمًا مع سلوك المتدرّب.
تخصيص البريد الإلكتروني
يمكن إرسال جميع الرسائل من بريد إلكتروني رسمي تابع للمؤسسة (مثل: training@yourorg.sa)، ما يعزّز مصداقية التواصل.
مُعرّف الرسائل القصيرة (SMS Sender ID)
يتيح إظهار اسم المؤسسة في رسائل الجوال بدلاً من رقم عام، ليعكس هوية واضحة ويوفّر ثقة أكبر في الرسائل المرسلة.
الأكواد المخصّصة (Custom Code)
تسمح هذه الميزة بإضافة أكواد برمجية مخصصة لأغراض مثل تتبع السلوك التدريبي، أو ربط أدوات تحليلات خارجية، أو تحسين واجهة الاستخدام بحسب الحاجة.
الخلاصة: المنصّة ميدان للتجريب لا للإنجاز
ليست كل منصّة تدريبية دليلًا على وجود تدريب حقيقي. في بيئة العمل المعقّدة اليوم، المنصّة بحاجة أن تكون انعكاسًا لرؤية المؤسسة في التدريب، وأداة لصياغة تجربة تعلّم تفاعلية، آمنة، وإنسانية. حين نُعيد التفكير في أهداف المنصّة، وندمج التجريب، والتفاعل، والتأمّل، والابتكار ضمن تصميمها، تصبح المنصّة مساحة تدريب فعّالة تعزّز المهارات والسلوكيات المهنية، لا مجرد واجهة تقنية.
المنصّة التي تعترف بأن النمو لا يُقاس بإكمال الدورات بل بعمق التجربة، هي التي تحقق الهدف الحقيقي للتدريب.